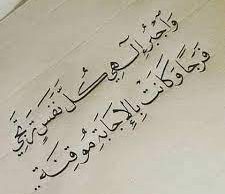ماجدة ريا ـ قصة قصيرة ـ
ما أن تسمع خبط أقدامه، حتى تعرف القادم، إنّه هواري.
فقد تميّز بلبس ذلك الحذاء، حتى لتخاله كأنه قطعة من قدمه الكبيرة، بلونه الأسود القاتم، وأشرطته السميكة التي ترتفع حتى نصف الساق، فهو من نوع (الرينجر) الأجنبي الصنع ـ وهو حذاء عسكري ـ لم يحصل عليه بسبب تجنّده بالجيش، وإنما حصل عليه من جهة يتفاخر بالتعامل معها، ويظنّ أنها ترضي غروره الفارغ.
وقد كان لثقل ذلك الحذاء، مضاف إليه عصبية ومزاجية حادة، وقع يرتجّ منه المكان، ويحدث وقراً في الآذان، التي لم يهتمّ يوماً بمراعاة أصحابها، أو يأبه لما يثيره في دواخلهم من تقزّز لحضوره؛ بل على العكس من ذلك، إذ أنّه بإمكانك أن ترى ومضة سخرية تطلّ من عينيه السوداوين، وبعض الخطوط التي ترتسم حول فمه الغليظ على نحافة جسمه. فقد كان نحيل القامة، طويلاً كجزع نخلة ذابل، تعلوها رأس تحمل بضع شعيرات، لا يتذكّر أحد سبب ضآلتها، هل هو قد ولد هكذا؟ أم أنّه قد فقد شعره لسبب آخر.
لم تكن خبطة قدمه فقط هي التي تميّز بها؛ بل كانت جزءاًََ من مشية يمشيها كطاووس متغطرس، رغم أنّه لا يملك من الطاووس لا جمال ريشه ولا لونه ولا مكانته من الطيور.
ينفر الناس من مجالسته، دون أن يُقرّوا لذلك سبباً واضحاً. فهل هم ينفرون من منظره؟ أو من طريقة تعامله؟ أو ربما مما يُشاع عنه هنا وهناك من أخبار لا تطمئن تجعل المرء يخشى الإقتراب منه؟
يتجوّل في القرية، معلناً عن وجوده، والناس مستنكرين لهذا الوجود، فيسعى لفرضه عليهم، ظنّاً منه أنّه إذا ضرب بحذائه في الأرض، وأحدث صدىً لصوته؛ يمكن أن يجعل لوجوده معنى، في الوقت الذي كان يضيع فيه الصدى ليصبح كصوت حفيف ورق أشجار الحور، صوت لا يسمن ولا يغني من جوع.
عندما كانت تلك الخبطة تتوارى، كان الناس يحصون أنفاسهم، ويترقّبون وقوع كارثة.
في ذلك اليوم التشريني الغامض، حيث كانت السمّاء تعكس تشوّشها على داخل هواري، جلس هذا الأخير مكتئباً يتساءل في نفسه، “لقد تأخّروا بالإتّصال بي!”
يجلس على مقعده الوثير الذي خصّصه للإسترخاء، لكنّ توتّره وعصبيته منعاه من ذلك، فجلس يهزّ ساقه بقوّة، ويخبطها بالأرض بينما لا أحد يسمع خبطتها سواه، إذ أخذ المنزل الفارغ يردّد وقع الصّدى؛ محدثاً في نفسه المزيد من الوحشة.
وهو في جلسته تلك، ينبعث صوت الجهاز منادياً؛ فيهبّ من مكانه كمن لسعته الكهرباء، ويتّجه نحوه، بدقّات قلب متسارعة؛ ليأتيه الصوت عبر الجهاز بنبرات واثقة، وصارمة:
ـ” نريد أن نراك، توجّه إلينا حالاً”.
وحدّدوا له المكان.
كان يجلس كأنّه متأهبٌّ لحدث ما وقد ارتدى زيّه المعروف، وكان جاهزاً للإنطلاق، لكن في هذه المرة كان يحاذر من أن يحدث أي صوت مريب، فيتلطّى من حائط إلى آخر، ومن شجرة إلى آخرى، إلى أن أصبح خارج حدود منازل القرية؛ فتنفّس الصعداء؛ ثمَّ هرول مسرعاً؛ مجدّاً للوصول، لكي يحصل على غلّةٍ أو مكافأة.
سلك طريقاً فرعية شقّتها أقدام المارة وسط الحشائش والنباتات البرّية، وهو يهرول بنصف انحناءة لكي لا يُرى، إلى أن بلغ أطراف الحرش الذي ضُرب فيه الموعد.
اتّسعت حدقتا عينيه دهشة واستنكاراً وهو يجد نفسه محاطاً بمجموعة من رجال المقاومة، وابتسامات السخرية تعلو وجوههم، وقد ازداد رعباً عندما التقت عيناه بعيني “ملاك”؛ ذلك الشاب الذي كان آخر من وشى عنه للعدو الصهيوني؛ فأخذ يرتجف كورقة في مهبّ الريح، حتى سُمع صرير اطصكاك أسنانه المنخورة، وهي تحدث أزيزاً مزعجاً ومفرحاً في آن!
لم يكن لديه الوقت ليفكّر، كيف حدث ذلك؟ كيف استطاع رجال المقاومة اختراق جهازه والتّحدث إليه حتّى وصل إلى هنا؟ أي تقنية عالية مكّنتهم من هذا الإختراق؟ وآلاف الأسئلة التي كانت ستنخر رأسه لو أنّه بقي لديه وعي ليستوعب ما حدث، لكنّ جلّ ما دار في رأسه هو ضجيج لتكرار كلمة “لقد وقعت!”، وسُمع لدويّ وقوع كبريائه المدَّعاة صوتاً كالرعد القاصف اخترق آذان كلّ من عرفه أو لم يعرفه.
اقترب منه ملاك، طلب منه أن يخلع حذاءه، ويمشي أمامه حافياً، مطأطئاً، على تراب تلك الدرب الوعرة، حتى بلغا سجن العملاء.
12/11/2009
عدد الزوار:2225